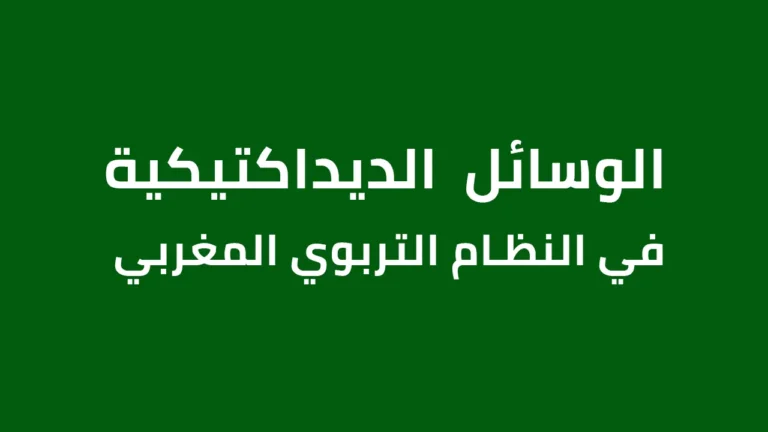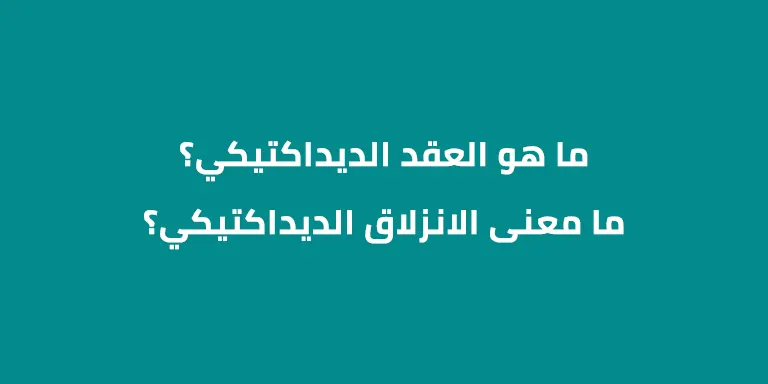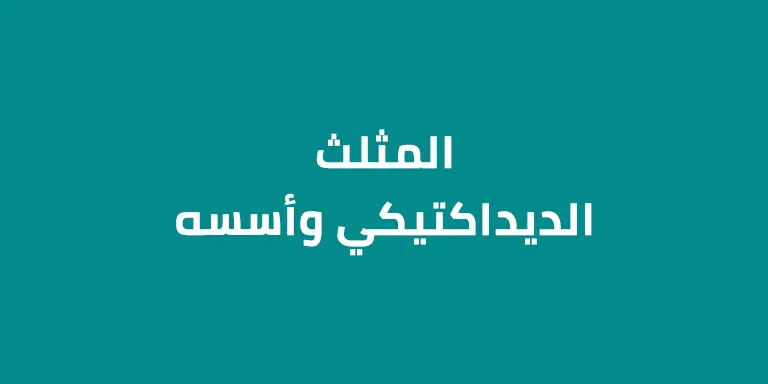لتحقيق تدريس فعّال وناجع، يجب أن يستند المدرس إلى علم الديداكتيك، أو ما يُعرف بـ علم التدريس. هذا العلم لا يعمل في فراغ، بل ينقسم إلى مستويين متكاملين ومتفاعلين: الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص. فهم العلاقة والفروق الجوهرية بين هذين المستويين هو حجر الزاوية لأي ممارسة تربوية ناجحة.
فهرس المقال
الكلمة المفتاحية الفرق بين الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص تُعدّ من الأسئلة الأكثر أهمية في حقل علوم التربية، والإجابة عنها تكمن في تحديد مجال تركيز كل منهما: هل نركز على القواعد الشمولية المشتركة بين جميع المواد؟ أم نركز على خصوصية مادة معينة؟
1. الديداكتيك العام: الإطار الشمولي ومصنع القواعد
يُمكن النظر إلى الديداكتيك العام (Didactique Générale) على أنه الفلسفة العامة أو المرجعية النظرية الشمولية التي تحكم العملية التعليمية/التعلمية بأكملها. إنه يهتم بالبحث عن القوانين والمبادئ التي تسري على تدريس جميع المواد الدراسية، بغض النظر عن محتواها العلمي (سواء كانت فيزياء، لغة، أو رياضيات).
أ. تعريف الديداكتيك العام
هو العلم الذي يهتم بتقديم المبادئ الأساسية والقوانين العامة والمعطيات النظرية التي تتحكم في العملية التربوية، من مناهج، وطرائق تدريس، وأساليب تقويم، وذلك بغض النظر عن خصوصيات المحتويات الدراسية.
ب. مجالات تركيز الديداكتيك العام
يركز الديداكتيك العام على دراسة الجوانب المشتركة التالية:
- المفاهيم المؤسسة: يهتم بدراسة وتأصيل المفاهيم التي لا ترتبط بمادة واحدة، مثل نظرية الوضعيات الديداكتيكية، التفويض، والعقد الديداكتيكي.
- المرجعيات الكبرى: يستمد أسسه من علوم التربية، وعلم النفس (سيكولوجية التعلم)، وعلم الاجتماع (سوسيولوجيا المدرسة)، ونظريات التعلم (كالبنائية والمعرفية)، ويطبق مبادئها على التدريس بشكل عام.
- عناصر المثلث الديداكتيكي: يحلل العلاقة بين المدرس والمتعلم والمعرفة كأقطاب متفاعلة، دون التدقيق في نوع هذه المعرفة. على سبيل المثال، يدرس كيفية تصميم درس بشكل عام، أو كيفية تقويم الطلاب بشكل شمولي.
- النقل الديداكتيكي العام: يضع القواعد العامة لعملية تحويل المعرفة الأكاديمية (العالمة) إلى معرفة قابلة للتدريس (المُدرّسة).
إقرا المزيد: ما هو الديداكتيك العام؟ – الاستعداد لمباراة التعليم
2. الديداكتيك الخاص: التخصص العميق وتكييف الطرائق
إذا كان الديداكتيك العام هو الإطار، فإن الديداكتيك الخاص (Didactique Spécialisée/Des Disciplines) هو التطبيق المنهجي والعميق لهذه القواعد العامة على مادة دراسية محددة بذاتها. إنه ينزل من مستوى الشمول إلى مستوى الخصوصية، حيث يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الإبستمولوجية (علم المعرفة) الخاصة بكل مادة.
أ. تعريف الديداكتيك الخاص
هو المنهج المتبع لتخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريس لـ مادة معينة (كديداكتيك اللغة العربية، ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك الفيزياء). ويهتم بتحليل الطرائق، والوسائل، والأساليب الخاصة بتلك المادة لتحقيق أهدافها.
ب. مجالات تركيز الديداكتيك الخاص
يركز الديداكتيك الخاص على الجوانب المتخصصة التالية:
- طبيعة المحتوى: يحلل المنطق الداخلي للمادة. فمثلاً، يدرس ديداكتيك الرياضيات العوائق الإبستمولوجية المرتبطة بمفهوم “الصفر” أو “المالانهاية”، والتي لا تظهر في تدريس مادة اللغة.
- التكييف والتحويل: يهتم بـ تكييف وتحويل المعرفة كما تظهر في الكتب المدرسية والبرامج، لضمان ملاءمتها لمستوى المتعلمين وإتقانهم. هذا يتطلب تحديد الوسائل الديداكتيكية (كالأدوات والمجسمات) الملائمة لكل مفهوم.
- العوائق المحددة: يدرس العوائق الديداكتيكية التي يواجهها المتعلم عند تعلم مفاهيم محددة (مثل صعوبة فهم القواعد النحوية في اللغة، أو صعوبة فهم الدارة الكهربائية في الفيزياء)، ويقترح استراتيجيات علاجية خاصة.
- تطوير الاستراتيجيات: يركز على ابتكار وتطوير طرق تدريس تابعة لتلك المادة، مثل استخدام “التحليل النصي” في اللغة العربية، أو “التجربة المخبرية” في العلوم.
3. الفرق بين الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص
يكمن الفرق بين الديداكتيك العام والخاص في نطاق البحث والتركيز:
أ- الديداكتيك العام
يُقدّم النظرية والمبادئ (كأن يقول: “يجب على المتعلم أن يُبنى معرفته بنفسه”).
- سؤال المحور: يتناول الديداكتيك العام السؤال الشمولي: “ما هي قواعد التدريس الصالحة للجميع؟” أي المبادئ التي يمكن تطبيقها على أي مادة دراسية.
- مجال التركيز: ينصب تركيزه على القواعد العامة، والنظريات السيكولوجية (كـعلم نفس النمو والتعلم)، وهيكلة المناهج بشكل شمولي.
- الغاية القصوى: يهدف إلى وضع إطار مرجعي وفلسفة عامة للتعليم، وتوفير الأساس النظري لكل الممارسات البيداغوجية.
- مثال عملي: يضع أسس تطبيق المقاربات الكبرى مثل تطبيق بيداغوجيا الكفايات بشكل عام (ما هي الكفاية؟ وما هي خصائصها؟).
ب- الديداكتيك الخاص
يُقدّم التطبيق والإجراء (كأن يقول: “لتطبيق مبدأ البناء الذاتي في مادة التاريخ مثلا، يجب استخدام طريقة التحليل الوثائقي والمقارنة”).
- سؤال المحور: يتناول الديداكتيك الخاص السؤال التخصصي: “كيف يمكن نقل مفهوم محدد من مادة معينة؟” أي كيفية تكييف المعرفة لتناسب مادته.
- مجال التركيز: يركز على المنطق الداخلي للمادة، والعوائق الخاصة بها (الإبستمولوجية)، وطرائق التدريس المتخصصة (كالمقاربة النصية في اللغة أو التجريب في العلوم).
- الغاية القصوى: يهدف إلى تحقيق الإتقان المعرفي والمهاري في التخصص، لضمان بناء المفاهيم بشكل سليم داخل عقل المتعلم.
- مثال عملي: يركز على التطبيقات الدقيقة، مثل كيفية تقويم “كفاية القراءة” في اللغة العربية، أو “كفاية حل المعادلات” في مادة الرياضيات.
العلاقة التكاملية: إن الديداكتيك العام والخاص مترابطان ويعملان معاً لتحسين جودة التعليم. الديداكتيك الخاص هو الذي يجسد مبادئ الديداكتيك العام ويختبرها في الواقع العملي للفصل. لا يمكن للمدرس أن ينجح في تدريس مادته (الخاص) دون فهم القوانين الكبرى للتعلم (العام).
إن التحدي الأكبر لأي نظام تربوي يكمن في دمج هذين المستويين بشكل فعال لضمان أن تكون الممارسات الصفية مبنية على أسس علمية صلبة وموجهة بوعي نحو خصوصية المادة والمتعلم. شرح الديداكتيك العام والخاص يوضح هذه العلاقة بشكل مبسط ومركّز.