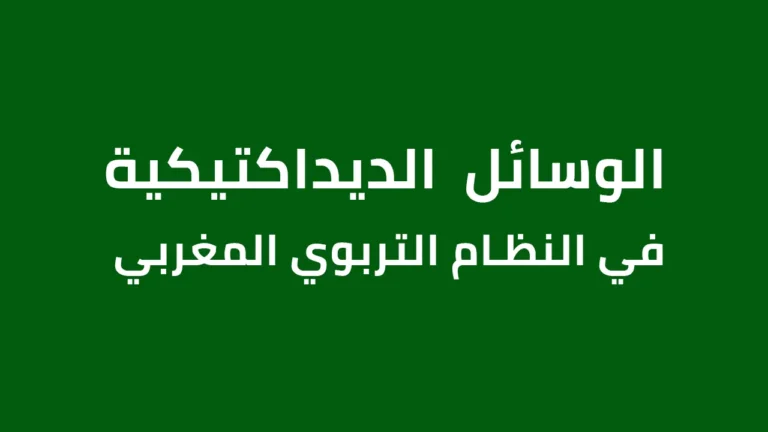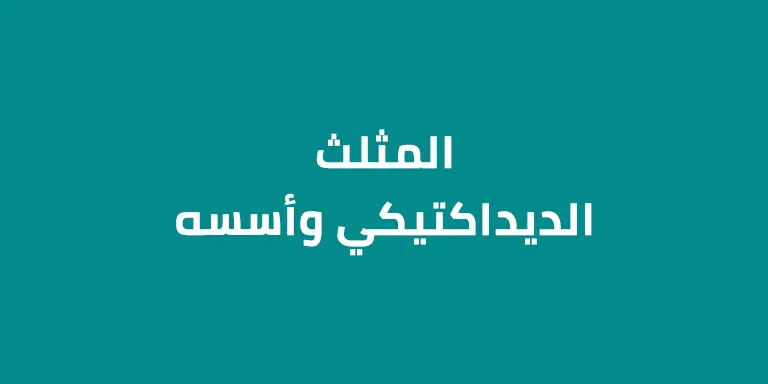يعد مفهوم العقد الديداكتيكي أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها علم التدريس الحديث، وهو يذهب إلى ما هو أعمق من اللوائح والقوانين الرسمية للمدرسة.
فهرس المقال
إذا كانت العملية التعليمية تقتضي تفاعلاً بين المدرس والمتعلّم والمعرفة (المثلث الديداكتيكي)، فإن العقد الديداكتيكي هو نظام القواعد والالتزامات غير المكتوبة التي تنظّم هذه العلاقة.
الكلمة المفتاحية العقد الديداكتيكي هي بوصلة المدرس لتحقيق النجاعة والجودة في التعليم، لكن هذا العقد، بسبب طبيعته الضمنية، يكون هشاً وعرضة لـ الانزلاقات الديداكتيكية، وهي أخطاء منهجية شائعة تكسر هذا التفاهم الضمني وتؤثر سلباً على عملية بناء المعرفة لدى الطالب.
لفهم لماذا يفشل المتعلم أحياناً، يجب أن نفهم أولاً كيف يتم خرق هذا العقد.
1- تعريف العقد الديداكتيكي
يُعرّف الباحث غي بروسو (Guy Brousseau)، رائد نظرية الوضعيات الديداكتيكية، العقد الديداكتيكي بأنه: “مجموع التصرفات المحددة للمدرس المتوقعة من المتعلم، ومجموع سلوكيات المتعلم التي يتوقعها المدرس، مجموع الالتزامات والجزاءات المتبادلة التي يقوم بها كل شريك في الوضعية الديداكتيكية”.
أ. طبيعته ومضمونه
- عقد غير حقيقي: العقد الديداكتيكي في الواقع ليس عقداً حقيقياً بالمعنى القانوني، لأنه لا يُبنى على موافقة حرة أو صريحة للمتعلم، بل يستمد شرعيته من واجبات المدرس تجاه المجتمع والمؤسسة التعليمية.
- الالتزام الضمني: هو عبارة عن اتفاق ضمني بين المدرس والمتعلم يحدد الأدوار والمسؤوليات، مثل: “المدرس سيعلمني بوضوح، وأنا ألتزم بالبحث والمحاولة”.
- المفارقة الصارخة: ينطوي هذا العقد على مفارقة عميقة تكمن في أن المدرس يطالب التلميذ بما لا يملك أو لم يتحصل عليه (المعرفة)، والمتعلم لا يملك شيئاً يتعاقد عليه، وإنما ينتظر من المدرس أن يمنحه إياه، هذا التباين هو مصدر الانزلاقات.
ب. أهمية العقد
يُعدّ العقد الديداكتيكي ضروريًا لـ:
- تحديد الأدوار: يوضح للمتعلم ما هو مطلوب منه تحديداً (المحاولة، التفكير، السؤال).
- خلق بيئة متوازنة: يضمن أن المجهود التعليمي ليس إجباراً بل التزام ضمني يحقق الدافعية.
- إضفاء معنى للتعلم: يجعل المتعلم شريكاً في عملية الوصول إلى المعرفة.
2- تعريف الانزلاقات الديداكتيكية
تحدث الانزلاقات الديداكتيكية عندما يتصرف المدرس بطريقة تتعارض مع التوقعات الضمنية للعقد الديداكتيكي، مما يؤدي إلى فشل في تحقيق التعلم الحقيقي (الاكتساب المعرفي)، وقد رصد الديداكتيكيون أربعة آثار سلبية رئيسية تنجم عن هذه الانزلاقات:
أ. أثر توباز (Effet Topaze)
- التعريف: يحدث هذا الأثر عندما يواجه المتعلّم صعوبة في الإجابة على سؤال أو حل مشكلة، فيقوم المدرس بـ تقديم مساعدة حاسمة ومباشرة تجعل الإجابة واضحة جداً، بدلاً من ترك المتعلم يبذل الجهد المعرفي اللازم.
- السبب: المدرس يطرح السؤال وفي ذهنه الجواب المحدد مسبقاً، ويستمر في طرح أسئلة إضافية (أو تلميحات) للوصول إلى الجواب الموجود في ذهنه، تماماً كما فعلت شخصية “توباز” في مسرحية مارسييل بانيول، الذي قدم لتلميذه الإجابة عندما سأله عن الخرفان.
- النتيجة: التدجين المعرفي للمتعلم؛ فهو لا يتعلم شيئاً حقيقياً أو يكتسب أي منهجية لحل المشكلات، بل يتم ترويضه على انتظار المساعدة الفورية.
ب. أثر جوردان (Effet Jourdain)
- التعريف: يحدث هذا الأثر عندما يُعلّق المدرس على جواب المتعلم بطريقة متعالمة أو مفرطة في التبسيط، فيظن المتعلم أنه أتى باكتشاف أو إجابة ذات قيمة عميقة، بينما هو في الحقيقة لم يتعلم سوى قاعدة بسيطة أو أمر بديهي.
- السبب: المدرس يتجنب النقاش العميق حول المعلومة ويكتفي بأدنى مؤشر صادر من المتعلم ليقدم القاعدة أو الخاصية بشكل سريع دون بنائها.
- المثال: عندما يصحح الأستاذ خطأً في عملية ضرب، ويقول للطالب: “أحسنت! أنت تعلم أن 1 مُحايد في عملية الضرب، وأن عملية الضرب تبادلية”، مما يخلق وهم الإتقان لدى الطالب، الذي يشعر بالفخر بما قام به رغم أنه لم يأتِ بشيء جديد.
- النتيجة: التظاهر بالتعلم؛ المتعلم لا يطور وعيه بخصوصية المعرفة.
ج. أثر بيجماليون (Pygmalion Effect)
- التعريف: يُعدّ هذا الأثر سيكولوجياً بالأساس، يشير إلى أن تقويم المدرس للمتعلم يتأثر بأحكامه وتوقعاته القبلية إزاءه.
- السبب: عندما يترسخ في ذهن المدرس أن تلميذاً معيناً “جيد وذكي”، فإنه يعامله بلا وعي بطريقة إيجابية (بما في ذلك لغة جسده، ونبرة صوته، وتعابير وجهه)، مما يزيد ثقة الطالب بنفسه ويحسن أداءه الفعلي في التقويم، والعكس صحيح للتلميذ الذي يُصنف مسبقاً كـ “متعثر”.
- النتيجة: التنبؤ الذاتي بالنجاح أو الفشل؛ تؤثر الأفكار المسبقة على نتائج التقويم والتحصيل الدراسي.
د. أثر المتباعد/المعرفي (L’effet Métacognitif)
- التعريف: يحدث هذا عندما يفشل المدرس في إكساب المتعلمين ما يريد إكسابهم إياه (لصعوبة المعلومة أو فشل الطريقة)، فيلجأ إلى تبرير هذا الفشل بـ صرف المتعلمين عن الموضوع الأصلي وتجنب مواجهة العائق المعرفي.
- السبب: عجز المدرس عن دفع المتعلمين نحو تحقيق الهدف المتوخى، فينتقل كتعويض عن فشله إلى مواضيع أخرى أو التركيز على أمثلة خارج سياق الدرس (مثل الحديث عن كرة القدم أو السياسة).
- النتيجة: تشتيت التعلم وتجنب العائق المعرفي، مما يعيق تحقيق الهدف الديداكتيكي للمادة.
إقرا أيضا: ما هو المثلث الديداكتيكي وأسسه؟
الخلاصة: أهمية الوعي الديداكتيكي للمدرس
إن العقد الديداكتيكي يظل نظاماً معقداً وضرورياً لترشيد العلاقة التربوية، إن الوعي بـ انزلاقات العقد الديداكتيكي ليس اتهاماً للمدرس، بل هو دعوة لـ اليقظة الديداكتيكية، أي أن يكون المدرس واعياً باستمرار لتصرفاته وتأثيرها الخفي على بناء المعرفة لدى المتعلم.
المدرس الكفؤ هو من يعمل على تفعيل مفاهيم مثل التفويض، حيث ينقل مسؤولية التعلم إلى المتعلم بشكل منهجي، ويحرص على أن يكون تدخله موقوتاً وموجهاً، وليس حلاً جاهزاً يقع في فخ أثر توباز أو جوردان.
لمزيد من التفصيل حول مفهوم العقد الديداكتيكي وانزلاقاته، يمكنك مشاهدة فيديو: الديداكتيك العام || مفهوم العقد الديداكتيكي ومفهوم الانزلاق الديداكتيكي.