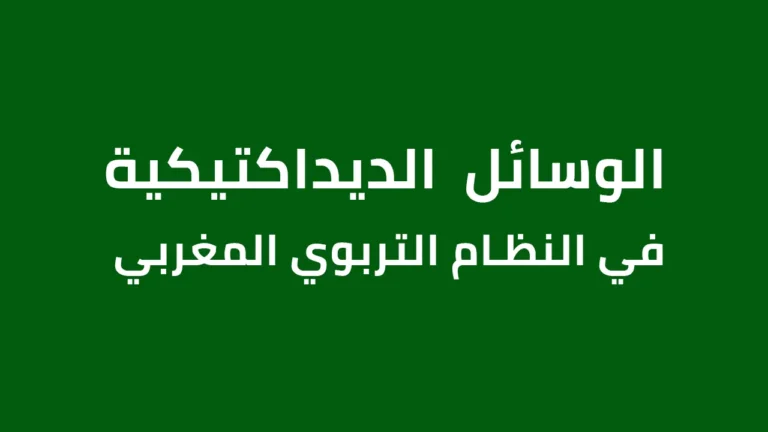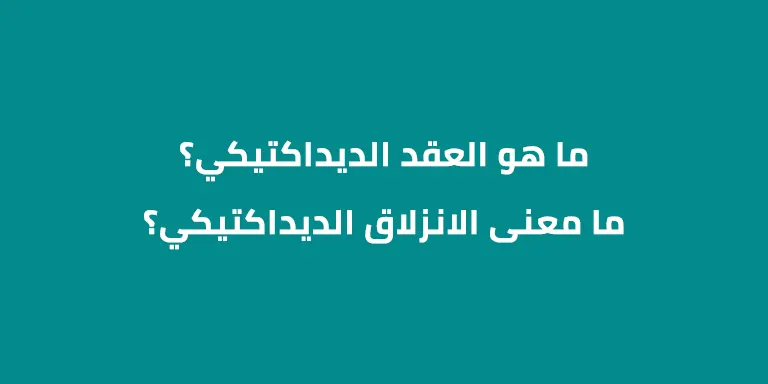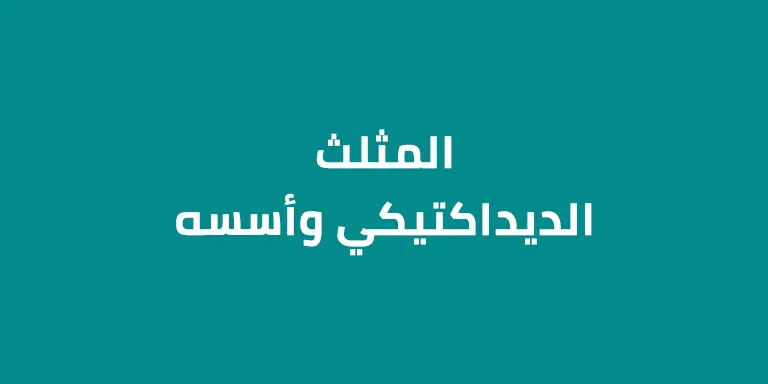لطالما كان مجال البحث الديداكتيكي (أو علم التدريس) في قلب التطور التربوي، لأنه لا يكتفي بوصف طرائق التدريس، بل يسعى إلى تحليلها وفهم آليات عملها وتأثيرها على بناء المعرفة في عقل المتعلم.
فهرس المقال
هذا العلم، الذي بدأ ينتشر بقوة منذ سبعينيات القرن الماضي على يد باحثين مثل غي بروسو، يرتكز على شبكة من النظريات والمقاربات التي تسعى إلى تحقيق هدف واحد: عقلنة العملية التعليمية.
1. كرونولوجيا ظهور البحث الديداكتيكي المعاصر
لم يكن الديداكتيك علماً قائماً بذاته في الماضي، بل كان جزءاً من الفلسفة والبيداغوجيا العامة، لكنه اكتسب استقلاله بفضل جهود بحثية مكثفة:
- البداية (1970 – 1980): بدأ غي بروسو في استكشاف أسئلة مادة الرياضيات للمدرسة الابتدائية، وكان عمله النواة الأولى لانتشار مصطلح “الديداكتيك”. تلا ذلك إنشاء أول مدرسة لديداكتيك الرياضيات، حيث اجتمع باحثون متخصصون لمناقشة المفاهيم الأساسية لهذا العلم.
- المفاهيم المؤسسة (1985 – 1990): ظهرت مفاهيم جوهرية شكلت مجالات بحث جديدة:
– النقل الديداكتيكي: قدمه إيف شوفيلارد للرياضيات، وهو مفهوم يعود في أصله إلى عالم الاجتماع ميشيل فيرت، ويدرس كيف تتحول المعرفة الأكاديمية إلى معرفة مدرسية.
– نظرية الحقول المفاهيمية: طورها جيرار فيرنيو، وهي نظرية معرفية تهدف إلى فهم كيفية نمو وتعلم الكفايات المعرفية المعقدة لدى المتعلم.
2. النظريات الثلاثة الكبرى في البحث الديداكتيكي
يُمكن تلخيص مجالات البحث الديداكتيكي المعاصر في ثلاث نظريات متكاملة، ينظر كل منها إلى العملية التعليمية من زاوية مختلفة:
أ. النظرية الأنثروبولوجية للديداكتيك
هذه النظرية طرحها إيف شوفيلارد ودعت إلى مقاربة المدرسة في علاقاتها بأشكال أخرى من المعرفة المجتمعية.
- الفكرة الأساسية: تفترض أن المعرفة ليست محصورة داخل جدران الفصل، بل “الديداكتيك كثيف في كل مكان”، أي أن التعليم متأثر ومتجذر في الثقافة، والتاريخ، والممارسات الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
- مجال البحث: دراسة الظاهرة التعليمية ليس كنشاط داخلي (فقط)، بل كـ ممارسة اجتماعية خاضعة للنقل الديداكتيكي والتأثيرات الثقافية والسياسية التي تحيط بالمعرفة. بمعنى، كيف يؤثر نوع المجتمع وغاياته السياسية على نوع المعرفة التي يتم تدريسها.
ب. النظرية المفاهيمية
تُركز هذه النظرية بشكل مكثف على المفاهيم المعرفية وكيفية بنائها داخل عقل المتعلم.
- الرواد: لورانس فيينو و جيرار فيرنيو.
- الفكرة الأساسية: تهدف إلى توفير إطار معرفي متماسك لدراسة النمو والتعلم والكفايات المعرفية، خاصة تلك المرتبطة بالعلوم والتقنيات، إنها تركز على جوهر المعرفة وكيف يتم تنظيمها (الحقول المفاهيمية) دون الخوض في رواسبها أو علاقاتها الخارجية المعقدة.
- مجال البحث:
– دراسة التمثلات (التصورات القبلية) لدى المتعلم حول مفاهيم علمية محددة.
– تحديد المسارات الذهنية التي يتبعها المتعلم لبناء مفهوم جديد.
– تحديد العوائق الإبستمولوجية (العوائق المرتبطة بطبيعة المادة المعرفية ذاتها) التي تمنع المتعلم من استيعاب المفهوم.
ج. النظرية السوسيولوجية
جاءت هذه النظرية لتُعالج غياب العدالة الديداكتيكية، وتدعم الطرح الاجتماعي في مقاربة الظاهرة التعليمية.
- الفكرة الأساسية: تركز على الأبعاد السوسيولوجية المتدخلة في الفعل الديداكتيكي. ترى أن الفوارق الديداكتيكية (مثل التباين في التحصيل الدراسي) هي نتاج الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الطلاب.
- مجال البحث:
– دراسة تأثير الممارسات الاجتماعية المرجعية (مثل عادات الطبقة الاجتماعية والأسرة) على طريقة تلقي المتعلم للمعرفة.
– تحليل العقد الديداكتيكي وعلاقات القوة غير المتكافئة بين المدرس والمتعلم، وكيف تساهم المؤسسة التعليمية في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية بدلاً من معالجتها.
إقرا أيضا: ما هو الفرق بين الديداكتيك و البيداغوجيا؟
3. الممارسة الديداكتيكية كعلم تطبيقي
يتجلى البحث الديداكتيكي عملياً في دراسة الوضعيات الديداكتيكية التي يضعها المدرس (وخصوصاً نظرية الوضعيات لغي بروسو)، وتحديد المفاهيم التي تُسهم في نجاح هذه الوضعيات، مثل:
- التفويض (La Dévolution): وهو فعل نقل مسؤولية وضعية التعلم إلى المتعلم.
- العقد الديداكتيكي: وهو الالتزام الضمني الذي ينظم العلاقات بين المدرس والمتعلم حول المعرفة.
- التمثلات: وهي التصورات المسبقة التي يجب على المدرس اكتشافها واستثمارها في عملية البناء المعرفي.
بهذه النظريات والمفاهيم، يبتعد الديداكتيك عن التفكير المجرد ليصبح دراسة علمية لطرق التدريس وتقنياته، تهدف إلى تحليل واقع التدريس وفهمه في البداية، ثم التخطيط، والتجريب، والتنظيم لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة.
هذا التطور يضمن أن يكون التدريس عملية مبنية على الوعي المنهجي لا الاجتهاد الشخصي.