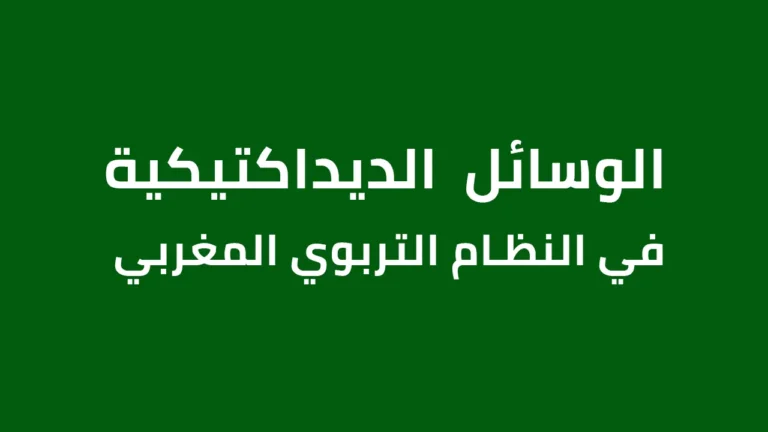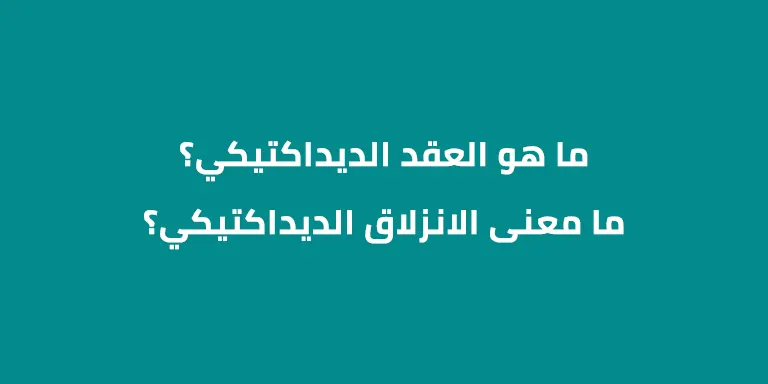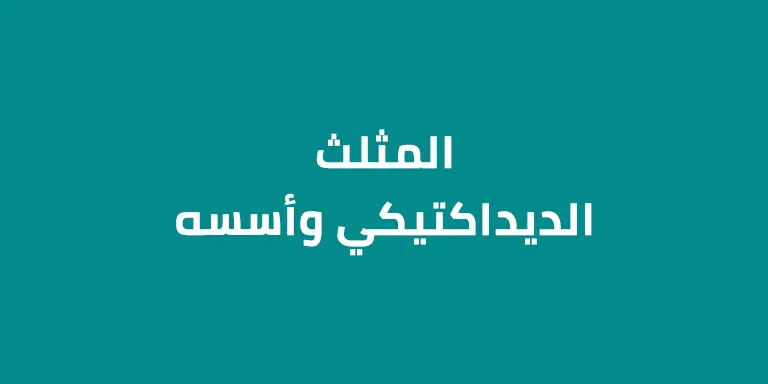كثيراً ما يتردد مصطلحا البيداغوجيا والديداكتيك في الأوساط التربوية، وقد يخلط الكثيرون بينهما، رغم أن كلاً منهما يمثل زاوية نظر مختلفة وحيوية داخل العملية التعليمية. البيداغوجيا والديداكتيك ليسا نقيضين، بل هما جبهتان متكاملتان تهدفان معاً إلى تطوير جودة التعليم وتحسين مهارات المتعلمين، لفهم الفارق الجوهري بينهما، يجب علينا أن ننظر إلى كل منهما على أنه يمثل مرحلة أو بعداً مختلفاً في رحلة المعرفة.
فهرس المقال
الكلمة المفتاحية التي يبحث عنها الجميع اليوم هي الفرق بين الديداكتيك والبيداغوجيا، ولن نستطيع تحديد هذا الفرق إلا من خلال تحليل دقيق لدور كل منهما وأقطابه الأساسية.
إذا كانت البيداغوجيا تهتم بـ “فن” تربية الطفل وتوجيهه بشكل عام، فإن الديداكتيك يهتم بـ “علم” نقل المعرفة وتوصيلها بفعالية.
1. البيداغوجيا: كيف نُعلّم؟
تشير المعلومات التي لدينا إلى أن البيداغوجيا هي مجموع المعارف والمنهجيات والتقنيات التي يستعين بها المدرس على إنجاز مهامه التعليمية، هذا التعريف الموجز يؤكد أن البيداغوجيا تهتم بالإطار العام الذي تتم فيه عملية التربية والتعليم.
أ. أصل المفهوم ومحور الاهتمام
- الأصل اللغوي: كلمة البيداغوجيا مشتقة من اليونانية (Paidagogos)، وتعني قديماً “العبد الذي كان يرافق الأطفال إلى المدرسة”، مما يدل على وظيفة التوجيه والإرشاد الشامل.
- المتعلم والعلاقة الإنسانية: تركز البيداغوجيا على المتعلم كـإنسان متكامل، وليس فقط كعقل يتلقى المعرفة، فهي تهتم بالجوانب النفسية، والعاطفية، والاجتماعية، والأخلاقية، هي التي تحدد المناخ الصفي الملائم والبيئة الإيجابية للتعلم.
- الجانب العام والنظري: هي أقرب إلى النظريات والفلسفات التربوية، مثل بيداغوجيا حل المشكلات، أو بيداغوجيا الخطأ، أو بيداغوجيا الإدماج، فهي لا ترتبط بمادة معينة، بل تضع مبادئ عامة لإدارة الفصل وبناء الشخصية وتنمية المهارات الاجتماعية.
ب. المثلث البيداغوجي لـ “جان هوساي”
اقترح البيداغوجي جان هوساي (1988) نموذج “المثلث البيداغوجي” لفهم البيداغوجيا، حيث يضم ثلاثة عناصر تدور حولها المقارنات في المواقف التربوية:
- المتعلم (Apprenant/التلميذ): وهو محور العملية، يشير إلى المتربين والمتكونين والمتعلمين.
- المدرس (Enseignant): وهو الموجه والمربي والمشرف والمرشد.
- المعرفة (Savoir): وهي المحتويات والتخصصات والبرامج والتعلمات.يركز هذا المثلث بشكل كبير على العلاقات (Relation) بين هذه الأقطاب الثلاثة، خاصة العلاقة البيداغوجية بين المدرس والمتعلم، والتي تتسم بالتوجيه والتربية.
إقرا المزيد: ملخصات جميع دروس البيداغوجيا
2. الديداكتيك: ماذا نُعلّم؟
بالمقابل، ينصب تركيز الديداكتيك على جانب أكثر دقة وتخصصاً، وهو المعرفة وكيفية تنظيمها لنقلها.
أ. أصل المفهوم ومحور الاهتمام
- الأصل اللغوي: كلمة الديداكتيك مشتقة من اليونانية (Didaktikos)، وتعني “كل ما له صلة بالتدريس أو التعليم”، مما يؤكد تركيزها على التقنيات المنهجية.
- المحور الأساسي: المادة الدراسية ومنطقها: تهتم الديداكتيك بـالمادة المدرسة (كديداكتيك اللغة العربية أو ديداكتيك الفيزياء)، وبـ البنية الإبستمولوجية للمادة (طبيعة المعارف التي تتكون منها المادة، وكيفية بناء مفاهيمها).
- الجانب التطبيقي والعلمي: هي أقرب إلى علم التدريس الذي يهدف إلى عقلنة وتنظيم تدريس معرفة محددة. الديداكتيك هو الذي يحدد الخطوات العملية لنقل المعلومة.
ب. المفاهيم المركزية في الديداكتيك
يُركز الديداكتيك على مفاهيم محددة تمثل الجانب التطبيقي للعملية التعليمية:
- النقل الديداكتيكي: عملية تحويل المعرفة من شكلها الأكاديمي “العالم” والمعقد إلى شكلها المدرسي “المُعلَّم” والمبسط، مع الحفاظ على جوهرها العلمي.
- العقد الديداكتيكي: مجموع القواعد والاتفاقيات الضمنية والصريحة التي تنظم العلاقة بين المدرس والمتعلم حول المعرفة (ما يجب فعله لإتقان المادة).
- تشخيص الصعوبات: يختص الديداكتيك بتشخيص العوائق التي تعترض تعلم مادة محددة (صعوبات خاصة بالرياضيات، صعوبات خاصة باللغة)، والعمل على وضع خطط علاجية لها.
إقرا المزيد: ما هو الديداكتيك العام؟ – الاستعداد لمباراة التعليم
3. الفرق بين الديداكتيك والبيداغوجيا
لتبسيط الفكرة وتحديد الفرق بين الديداكتيك والبيداغوجيا بشكل واضح، يمكننا تلخيص العلاقة في أن البيداغوجيا هي الإطار العام الذي يحتوي الديداكتيك:
البيداغوجيا
- سؤال المحور: كيف نُربّي؟ كيف نُدير الفصل؟ كيف نُشجّع ونُحفّز المتعلم؟
- طبيعة العمل: عام ومتعدد التخصصات.
- مجال الاهتمام: تهتم بشكل أساسي بـ المناخ التربوي والوجداني داخل وخارج الصف.
- العلاقة المهيمنة: العلاقة البيداغوجية (المدرس – المتعلم). هي علاقة تربية وتوجيه شاملة.
- النتيجة المستهدفة: تنمية شخصية المتعلم وتأهيله اجتماعياً وأخلاقياً وجدانياً.
- الخلاصة: هي الفلسفة والأخلاق والنظريات التي تنظم كل ما يحيط بالمتعلم.
الديداكتيك
- سؤال المحور: ماذا نُدرّس؟ وكيف نُبسّط وننقل هذه المادة بالذات؟
- طبيعة العمل: خاص ومرتبط بالمواد (ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك اللغة، إلخ).
- مجال الاهتمام: تهتم بشكل أساسي بـ تحليل المعرفة وبنيتها وكيفية تنظيمها.
- العلاقة المهيمنة: العلاقة الديداكتيكية (المعرفة – المتعلم). هي علاقة بناء مفاهيم وإتقان محتوى.
- النتيجة المستهدفة: ضمان اكتساب المتعلم لمعرفة ومهارات محددة بشكل سليم وعلمي.
- الخلاصة: هي المنهجية والأدوات التي تُعنى بـ المادة الدراسية ذاتها لضمان وصولها الصحيح.
علاقة التكامل
- البيداغوجيا توفر البيئة الإنسانية للتعلم.
- الديداكتيك يوفر المنهج العلمي لتدريس المحتوى داخل هذه البيئة.
- كلاهما ضروري لنجاح العملية التعليمية.
يمكن القول بأن البيداغوجيا هي المظلة الواسعة التي توفر مناخاً صحياً للتعلم، بينما الديداكتيك هو الخبير المتخصص الذي يصمم المادة التعليمية داخل هذا المناخ، المدرس المتميز هو الذي يجمع بينهما؛ يستخدم البيداغوجيا ليُحسّن بيئة التعلم والعلاقات، ويستخدم الديداكتيك ليُنظّم محتوى المادة ويضمن وصوله العلمي للمتعلم.
خاتمة
في النهاية، لا يمكن أن ينجح إصلاح تعليمي دون الجمع بين هذين العلمين، فإذا كانت البيداغوجيا تمنحنا النظريات والقواعد الأخلاقية للتعامل مع المتعلم (الجانب الوجداني والاجتماعي)، فإن الديداكتيك يمنحنا الأدوات المنهجية والتقنية لتفكيك المعرفة وبنائها في عقل المتعلم (الجانب المعرفي والإبستمولوجي)، الديداكتيك هو جزء تطبيقي من البيداغوجيا، حيث ينزل نظرياتها إلى أرض الواقع داخل الفصل، مركزاً على خصوصية كل مادة.
لذلك، فإن نجاح أي عملية تدريسية يتوقف على قدرة المدرس على الانتقال بسلاسة بين دور المربي البيداغوجي الذي يهتم بظروف تلاميذه، ودور المهندس الديداكتيكي الذي يعالج محتوى المادة ليصبح سهلاً ومفهوماً للجميع.
لمزيد من التفصيل حول هذه المفاهيم، يمكن مشاهدة هذا الفيديو: الفرق بين البيداغوجيا والديداكتيك.
هذا الفيديو يشرح بتعمق الفروقات الثلاثة الأساسية بين البيداغوجيا والديداكتيك، مركزاً على اهتمام كل منهما.