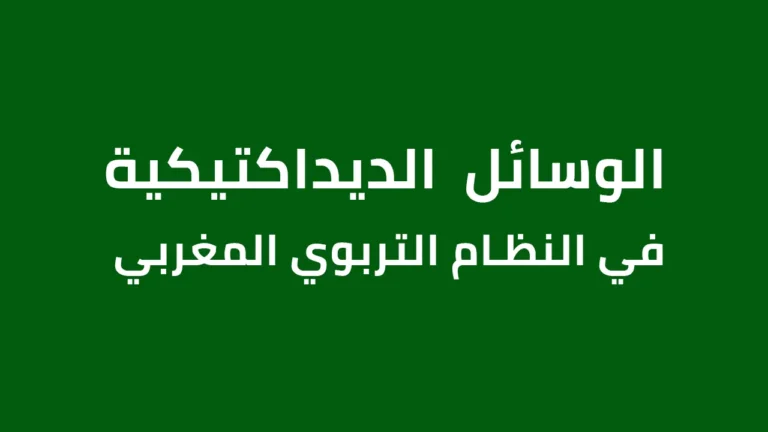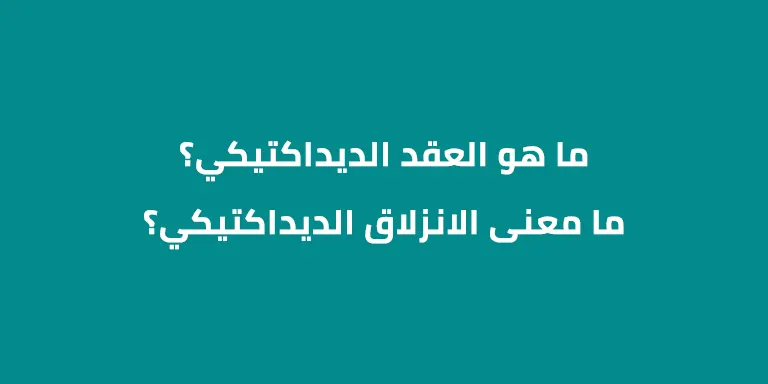1- ما هو المثلث الديداكتيكي؟
يُعدّ المثلث الديداكتيكي (Le Triangle Didactique) النموذج الأساسي والأكثر شيوعاً في التعليمية (الديداكتيك)، فهو يمثل خريطة طريق لفهم وتحليل أي وضعية تعليمية/تعلّمية. ببساطة، هو شكل هندسي ثلاثي الأقطاب يوضح أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا بوجود وتفاعل ثلاثة عناصر رئيسية: المدرس، والمتعلّم، والمعرفة (أو المادة الدراسية).
فهرس المقال
يُستخدم هذا النموذج، الذي طوره باحثون أمثال إيف شوفيلارد (Yves Chevallard) وجان هوساي (Jean Houssaye)، لوصف التفاعلات المعقدة التي تحدث في الفصل. إنه يضع المدرس أمام مسؤولية مزدوجة: فهم طبيعة المعرفة (الجانب الإبستمولوجي)، وفهم طريقة تفكير المتعلم (الجانب السيكولوجي)، والعمل على التوفيق بينهما في علاقة منظمة (الجانب البيداغوجي).
2- الأقطاب الثلاثة للمثلث الديداكتيكي
يتكون المثلث الديداكتيكي من ثلاثة رؤوس متفاعلة، يمثل كل منها قطباً معرفياً أو إنسانياً:
أ. قطب المعرفة (Savoir)
- الدور: يمثل المحتوى العلمي والمفاهيم التي يجب نقلها. تُعرف هذه المعرفة باسم “المعرفة المُدرَّسة”، وهي المعرفة التي خضعت لعملية تكييف وتحويل من حالتها الأكاديمية “العالمة” إلى حالتها المبسّطة “المُتعلَّمة”.
- العملية المرتبطة: الإعداد/التطوير (Élaboration)، وهي الجهود المبذولة لتنظيم وتبسيط المادة.
ب. قطب المدرس (Enseignant/Formateur)
- الدور: هو المهندس والمخطط للعملية. دوره لا يقتصر على الإلقاء، بل يشمل التخطيط، والتدبير، والتقويم، وتنظيم الوضعيات التعليمية. يجب أن يكون لديه تمكّن ديداكتيكي وبيداغوجي عالٍ.
- العملية المرتبطة: التدريس/التدخل (Enseigner/Intervention)، وهي الإجراءات التي يتخذها المدرس لتوصيل المعرفة.
ج. قطب المتعلّم (Apprenant/Élève)
- الدور: هو الركن الأساسي للعملية التعليمية وسبب وجودها. هو الطرف الذي يكتسب المعرفة ويقوم بـ بناء المفاهيم استناداً إلى مكتسباته السابقة وتصوراته القبلية (التمثلات).
- العملية المرتبطة: التعلم/التملك (Apprendre/Appropriation)، وهي السيرورة الذهنية التي يقوم بها المتعلم لاستيعاب المادة وجعلها جزءاً من بنيته المعرفية.
3- محاور المثلث الديداكتيكي
يتشكل المثلث بثلاثة أضلاع، يمثل كل ضلع منها علاقة بين قطبين، وهذه العلاقات هي ما تُحدد طبيعة العملية التعليمية.
أ. المحور الإبستمولوجي (المدرس ↔ المعرفة)
- الإشكالية: إشكالية النقل (Problématique de la transmission).
- التعريف: هو علاقة المدرس بالمادة العلمية، ويُطلق عليه أيضاً محور المعرفة المُعلَّمة. يركز هذا المحور على كيفية تحويل المعرفة الأكاديمية إلى معرفة مدرسية يسهل تدريسها دون تحريف جوهرها العلمي، وهي العملية المعروفة باسم النقل الديداكتيكي.
- الأهداف: تحديد الأهداف التعليمية، وتنظيم المحتوى، واختيار الطرائق المناسبة للمادة (مثل ديداكتيك الرياضيات أو اللغة).
ب. المحور السيكولوجي (المتعلّم ↔ المعرفة)
- الإشكالية: إشكالية التملك (Problématique de l’appropriation).
- التعريف: هو علاقة المتعلّم بالمادة الدراسية، ويُطلق عليه أيضاً محور إقبال المتعلّم على المعرفة. يركز هذا المحور على التمثلات (التصورات القبلية للمتعلم)، والدافعية، والفروق الفردية، وعلم النفس المعرفي.
- الأهداف: تشخيص العوائق المعرفية والسلوكية التي يواجهها المتعلم (العواقب الديداكتيكية)، ومعالجتها لتحقيق التملُّك الفعلي للمفاهيم.
ج. المحور العملي (المدرس ↔ المتعلّم)
- الإشكالية: إشكالية العلاقة (Problématique de la relation).
- التعريف: هو العلاقة البيداغوجية المباشرة بين المدرس والمتعلم، ويُطلق عليها أيضاً المحور البيداغوجي (Praxéologique).
- الأهداف: تنظيم العمل في الفصل، وإدارة التفاعلات، وتحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة من خلال مفاهيم مثل العقد الديداكتيكي والتفويض.
4- مفاهيم حيوية تحكم المثلث الديداكتيكي
يولد التفاعل بين أقطاب المثلث مفاهيم ديداكتيكية أساسية لا يمكن للمدرس الناجح أن يتجاهلها:
أ. النقل الديداكتيكي (Transposition Didactique)
هي العملية التي يتحول بها المحتوى من حالته الأكاديمية المعقدة (“المعرفة العالمة”) إلى معرفة قابلة للتدريس في المدرسة (“المعرفة المُدرَّسة”). يتم هذا النقل على مرحلتين: النقل الخارجي (اختيار المعرفة من قِبل واضعي المناهج)، والنقل الداخلي (تكييف المدرس للمادة داخل القسم).
ب. التمثلات (Représentation)
هي الأفكار والتصورات والمعتقدات التي يحملها المتعلم مسبقاً حول موضوع ما. المثلث الديداكتيكي يؤكد على أن التعلم الفعّال يجب أن ينطلق من هذه التمثلات، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، لاستثمارها في بناء المعرفة الجديدة.
ج. العقد الديداكتيكي (Contrat Didactique)
هو نظام القواعد والالتزامات (الضمنية أو الصريحة) التي تنشأ بين المدرس والمتعلم بخصوص المعرفة وطرائق اكتسابها. هذا العقد يحدد ما هو متوقع من كل طرف لضمان سير الدرس بفعالية، ويلزم الطرفين بالقيام بما يخدم العملية التعليمية.
د. التفويض (La Dévolution)
هو “فعل” حيوي ينقل بواسطته المدرس مسؤولية وضعية التعلم إلى المتعلّم. في التفويض، لا يُقدم المدرس الإجابة جاهزة، بل يُصمّم وضعيات تجعل المتعلّم يبحث بمفرده، مع قبوله لعواقب هذا النقل.
إقرا أيضا: النظريات الديداكتيكية: الأنثروبولوجية – المفاهيمية – السوسيولوجية
5- أهمية تحقيق التوازن وتجنب الانحرافات
يُشدد الديداكتيكيون على أن النجاح في العملية التعليمية مرهون بـ التوازن بين الأقطاب الثلاثة. إن تغليب أي قطب على حساب الآخرين يؤدي إلى انحرافات ديداكتيكية:
- تغليب المعرفة على المتعلّم والمدرس: ينتج عنه انحراف المقررات (التركيز على إنهاء المقرر مهما كان الثمن)، وتحويل المدرس إلى مجرد مُلقّن للمعلومات، والمتعلّم إلى وعاء سلبي.
- تغليب المتعلّم على المعرفة والمدرس: يُنتج انحراف التحرر المطلق (التعليم اللاتوجيهي غير المنظّم)، حيث يتلاشى الدور العلمي للمادة والمدرس، ويسود نوع من الفوضى غير المنتجة.
- تغليب المدرس على المعرفة والمتعلّم: يُنتج انحراف السلطة، حيث يتحول الفصل إلى مكان لفرض سلطة المدرس وقيمه دون مراعاة لمنطق المعرفة أو احتياجات المتعلّم.
لذلك، فإن مهمة المدرس الحديث هي العمل على تدبير التفاعلات بين الأقطاب الثلاثة ببراعة لضمان عدم انزلاق العملية نحو أي من هذه الانحرافات، وتحقيق تعلم ذي معنى وفعالية.
لمزيد من الفهم حول مكونات المثلث الديداكتيكي، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو: المثلث الديداكتيكي: مكوناته وأدواره.